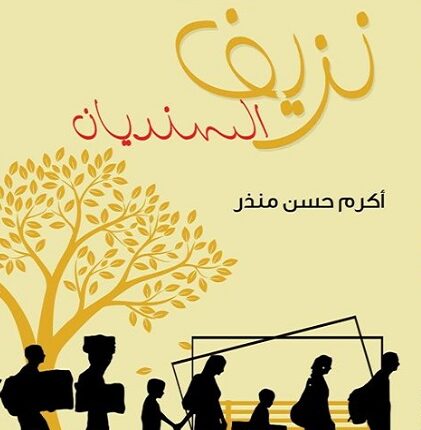
حين يثأر الكاتب من التاريخ.. قراءة في رواية “نزيف السنديان” لـ أكرم منذر
نافلة القول إن أكرم منذر كان قد حقق جزءا كبيراً من أهم شروط الادب وهو شرط المتعة.. أبدأ هنا من قراءة لرواية (نزيف السنديان).. الكتاب الذي انتهى بـ 240 صفحة من القطع المتوسط ضمن 39 فصلاً كانت تتجارى تباعاً بسلاسة دون تشكيل اي إرهاق للقارئ أو ملاحقة للترقيم كعادة البعض بفعل طريقة العديد من الكتّاب بإطالة الفصول أو الأقسام كما يرد في الكثير من الروايات سيما الحقل الروسي منها، رغم أنى من مريدي هذا الأدب، لكنه يفعل بي ما يفعله الاستهلاك الذهني والجسدي، هذا ما لم يقاربه أكرم في نصه المذكور. اسلوب سردي يواطئ القارئ المبتدئ والمثقف القارئ، لذا كانت محاولة الكاتب هي الوقوف على مسافة معتدلة من جميع من يقرر أن يكون أكرم أحد كتّاب رفوفه المنتقاة بعناية.
للكاتب ثأره الخاص
“عام 1856م صدرت عن الباب العالي قرارات نوعية رفعت بعض المظلومية عن الأقليات التي ترزح مع الأكثرية تحت الاحتلال العثماني إرضاءً لأوروبا المسيحية بعد أن احتل الوالي الألباني والي مصر عام 1831 الجزيرة العربية وبلاد الشام حتى هضبة الأناضول”.
قد توحي هذه الرواية بأنها تاريخية، لكن من محّص في سطورها سيكتشف أن كاتبها حمل على عاتقه مهمة التذكير قبل أن تكون قضيته هي التأريخ، انتقام أكرم من التاريخ مبرر في كل جزئية بدت أنها توثيق، أحداث ومواقف واقعية جعلت من التاريخ عدواً لكل أبناء منطقة الشرق الهزيل، تاريخ حول الشرق إلى شرخ، عاث فساداً بمفاهيم الانتصارات والهزائم، حول الأبطال إلى أشخاص مسحوقين، وجعل من الطغاة أساطير لا تُقهر، هو ينتقم من التاريخ بجعل النص مفتوحاً كي لا يفعل التاريخ فعلته كل مرة، لذا كان لزاماً تعرية كل تلك الحقب من ثيابها فرنسية الصنع، إنجليزية الطعم وعثمانية الشكل، وإلباسها طابعاً وطنيّ الحلة، بسيط الطلة، عظيم الأخلاق، كما أهلها الصادقون بمعظمهم، وكما هي عاداتهم وثقافتهم التي جعلت منهم ملوكاً فقراء.
“حرَرَنا الغزاة من الغزاة من أجل غزاة جدد.. تغيّر الغازي والغزوة واحدة” سينتقم الكاتب من كل فجيعة سياسية طالت تلك المنطقة، ومن كل حرب خلفّت وراءها الكثير من المجازر والمآسي، لكن على طريقته الخاصة ضمن أسلوب ذاك الراوي الذي يجالس شخوص العمل دون أن يدركوا أنهم في حضرته، ودون أن يشعرهم بوجوده حين يستعير أصواتهم، كي ندرك لاحقا أن بطل حكايتنا قد لعب دورين في ذات الوقت، شاهين الفارس، يخاطبنا تارة بصوته وشخصه القصصي، ويجعل من نفسه حكواتياً تارة أخرى، هذا الأسلوب قلما نجده في الأدب عامة، وهذا ما جعلني أقدم هذه الرواية بداية القول على أنها أمتعت في الكثير منها، للدرجة التي قد تجعل أحياناً من هذا النص بديلاً عن محركات البحث عن الإنترنت.
أكرم منذر تواطأ مع ذوبانه الشاعري
“ما بين الممكن المباح والحلم المستحيل تنتفي السكينة.. يفيض بوح عطور الرياحين والزنابق حتى فضاءاتنا.. لكننا على الضفة الأخرى من نهر الحياة”.
يبدو أن أكرم منذر أفرط في شاعريته في كثير من مواضع العمل، وهذا يتضح من حواريات أشخاصه اللذين لم يظهر أنهم ضليعون في اللغة والشعر كبيئة ترعرعوا فيها، إذ لم نلحظ أي مرجعيات ثقافية تكمن خلف هذه الشخصيات، سيما أن جلّ الشخصيات كانت تتحدث بطريقة أقرب للرومنسية والحكمة، لكن ما يبرر هذا الفعل أن أفراد العمل كانوا يتحدثون من منطق اللاوعي النابع من إرث مأساوي وُلدوا عليه، واعتادوا الحرب والحب في آن معاً، وكما عادةُ الكوارث فإنها تفرز منطقاً خاصاً بأصحابها يجعل من تجربتهم الحياتية اسلوب للعيش والكلام، من وجهة نظر أخرى، باعتقادي أن ما فعله الكاتب من سرد شاعري كان محاولة للتخفيف على القارئ وطأة هذا النزيف الدامغ.
أستطيع القول إن ما بين الرومانسية اللغوية وما بين التصنيف التأريخي، كان أكرم يحجز مقعداً ما بين شكسبير وأمين معلوف، كان هاملت الجديد حاضرا، لكن شاهين الفارس أيضاً تفوق على طانيوس أمين معلوف.
فلسفة وضعية
“وُجد المال ليخدم حياتنا.. والعمل ليعطيها قيمة.. والنجاح ليجملها”
قبل أن ينطق الكاتب بلسان شخصياته، كان عليه أن يقيم علاقة ثابتة معهم، إنسانية السلوك، مادية البناء، كان عليه أن يخترق الكثير من الحواجز النفسية لهم كي يصل لبئر عميق يكتب فيه ما توصل إليه من تجارب ووقائع حياتية تنم عن إمكانية الوصول إلى رؤية خاصة به، لكنه اختار أن يكون في الظل، كي تبقى نازك وشاهين وبثينة والعم الياس والمعلم انطون دائما في النور، وهكذا بدورنا نحن القرّاء لم نسلم من توريط أنفسنا في علاقة متعدية مع هؤلاء البشر المكتوبين على أوراق من السنديان.
أسئلة كبرى.. مابين المنطق الممكن.. والعبور المستحيل
“- هل ستنصفنا الحياة؟
– وهل سننصف أنفسنا؟
– هل أهملتِ نفسك يا ست الحضور والعطور أم أهملوك؟
لماذا قسوت علينا يا دمشق؟”
لماذا كان على الكاتب أن يطرح هكذا أسئلة؟
هل نحن معنيون بهذه الأسئلة أم بإجاباتها؟
والأهم.. هل كان يحاول أن يجعلها أسئلة مفتوحة.. أم مغلقة!
كي نتفادى الاستغراق في هذه الإشكالية المستفحلة في البعيد، وألا نستقصي في المعنى، يكفي أن نكون أمام مفارقة تراجيدية بحجم الحياة والموت، بدايات المكان ونهايات الوقت، ما يؤلم حقاً، هو ألا تكون الحياة جميلة، وغير منصفة.
يقول الكاتب والعالم الإنكليزي توماس هكسلي: البؤس عود كبريت لا ينطفئ أبداً.
وبالرغم مما يبدو أن ثمة صراعاً دام طويلاً لدى أكرم منذر ما بين مقاومته لفكرة انعدام الأمل حين أعطى شاهين حياة جديدة في لبنان، ثم سلبه إياها في دمشق وبعدها في قريته، قرر أن يتعافى من استسلامه أمام خيارات كثر، منها الثِّقَل الوجودي، عبثية الحياة والحب، ونزيف التاريخ والذاكرة والوطن، نزيف الجرح الذي ما برح يتفتق في كل مرة يقول فيها الإنسان لنفسه: أي فرصة للنجاة!
