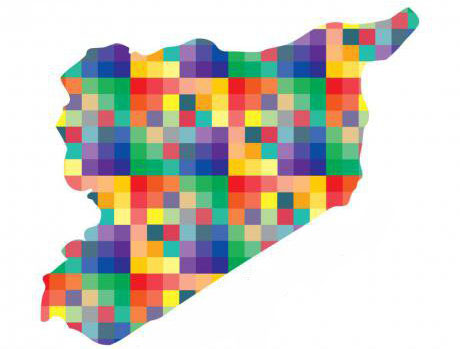
حول أسطورة الفسيفساء السورية
بين يدي كتاب “سورية والانتداب الفرنسي“ للكاتب البريطاني ستيفان هامسلي لونغريغ، أحد المسؤولين البريطانيين الذين رافقوا الانتداب البريطاني على العراق وعملوا هناك لعدة سنوات، وزار سورية لفترات طويلة بين 1925-1950، وتعرف على العديد من المسؤولين الفرنسيين والسوريين واللبنانيين. وسنحت له الفرصة لمزج تجاربه ومشاهداته الشخصية بالاطلاع على الكثير من المراجع والوثائق التاريخية، مما شجعه على وضع كتابه الذي يمكن أن يكون مرجعاً في دراسة تلك المرحلة من تاريخ سورية الحديث.
الملاحظة الأولى التي تلفت النظر في مقدمة هذا الكتاب هي انطلاقه من مسلَّمة بوجود هوية سورية كامنة ذات محتوى عربي منذ فترة طويلة لتلك البقعة الجغرافية “المحددة من الجنوب بالصحراء، وبالشرق بالسهوب التي تفصلها عن العراق الأوسط“. ومن الشمال الشرقي بالفرات الأعلى، وهنا يستطرد الكاتب: “مع أن المطالبات السورية بالجزيرة الشمالية والموصل نفسها معروفة جيداً قديماً وحديثاً” وغرباً بالبحر، وعلى سطحها الشمالي والشمالي الغربي ترتفع سلسلة جبال الأمانوس، ومن خلفها سهول (كيليكية)، وقد اعتُبرا أحياناً – ومعهما مناطق عينتاب ومرعش وأورفة وحتى ديار بكر الأناضولية – مناطق سورية “إن تضمين فلسطين في أيّة سورية جغرافية، أو تاريخية، أو إثنية – ثقافية هو على الأقل منذ العصور القديمة المتأخرة أمر لا نزاع فيه”.
لكن الكاتب يستدرك بسرعة أن ذلك لا يعني خضوع سورية التاريخية تلك لدولة واحدة مركزية في العهود التاريخية المتعاقبة (طبعاً، فإن الكاتب لا يأخذ بالاعتبار الدولة الأموية هنا). فمقاطعة سورية الرومانية، وولاية دمشق التركية (في الحقيقة جرى تسميتها بولاية سورية في الحكم العثماني)، والجمهورية السورية في عهد الانتداب الفرنسي لم تشمل سوى جزءاً من الأراضي السورية.
ترسم تلك الصورة السابقة التخومَ بين ما هو تاريخي – ديمغرافي للهوية السورية، وبين ما هو سياسي (الدولة – الحكم). هذه التخوم التي لم تكن يوماً متطابقة، ويمثل ذلك أحد أوجه الدراما التي خضعت لها سورية عبر تاريخها الطويل.
يستعرض الكاتب بعد ذلك وضع الأقليات في سورية، فيذكر أنها عموما تتشارك مع الأغلبية في اللغة والثقافة والعادات الاجتماعية إلى حد كبير: “من وجهة النظر السلالية، فإن المسيحيين – باستثناء الأرمن – بالكاد كانوا يختلفون عن الأغلبية الإسلامية”.
وأهم من كل ما سبق ما قرره الكاتب فيما يلي:
“إن الانطباع السائد حول سورية بوصفها فسيفساء من الأقليات يمكن أن يكون مضللاً، وذلك ليس لتجاهله الغلبة الكبيرة للسكان المسلمين السنة فقط، بل ولتشديده على نحو غير مطابق للواقع على العناصر التي تفصل الأغلبية عن بقية السكان، وتقليله من شأن الأرضية المشتركة الواسعة التي يلتقي عليها الجميع. وإذا كان قد وُجد حيز لسياسات الخصوصية المسيحية (يمكن أن نضيف خصوصيات الأقليات الأخرى التي لم يذكرها هنا الكاتب وقد ذكرها لاحقاً)، فقد وُجد حيز كذلك للتفكير وفق خطوط سورية، تعبر -دون تجاوز الاعتداد بالنفس والحريات المشروعة للطوائف- عن الوحدة الجوهرية للبلاد، والعهود الطويلة من التعايش المألوف، والأصول السلالية المشتركة، وتراث العروبة العظيم المشترك”.
بلا شك، لو أن عربياً سورياً كتب ما سبق اليوم، لخرج له عشرات المنتقدين ممن لديهم تهم جاهزة معلبة، تبدأ بـ“القومية الشوفينية“ ولا تنتهي بـ “اصطناع تاريخ مزيف لسورية يجعلها مجرد فسيفساء لشعوب مختلفة”.
بل يمكن – بثقة – القول إن سورية، بغالبيتها العربية، أكثر انسجاماً من كثير من دول العالم ذات الهوية الراسخة التي لا يفكر أحد في التعرض لها. فإيران تتكون من مجموعة شعوب مختلفة اختلافات عرقية ولغوية ودينية، بحيث لا يشكل العنصر الفارسي فيها أكثر من 51% من عدد السكان؛ ففيها – إضافة للفرس – الأذريون والكرد والعرب والبلوش وأقليات أخرى.
أما تركيا، فيشكل الأتراك بين 70-75%، حيث يبلغ عدد الأكراد فقط بين 18-20 مليوناً، وهناك أقليات أخرى أقل عدداً، منهم العرب والأبخاز والألبان والشركس واللاز واليهود واليونانيون.
وبالمقارنة، فإن نسبة العرب في سورية تزيد عن 90% من عدد السكان، فكيف تكون سورية فسيفساء؟
الهوية العربية – السورية ليست مسألة بحاجة إلى اكتشاف، فهي واضحة وضوح الشمس. لذلك، لم تكن موضع التباس بالنسبة لباحث بريطاني كان جزءاً من جهاز الانتداب البريطاني على العراق. فهل يمكن ألا يستطيع رؤيتها بعض السوريين حين يجادلون في أن “سايكس – بيكو” أوجدت سورية، بدل أن تكون قد قسمتها وسلخت أجزاء واسعة منها، خدمة لأغراض استعمارية بعيدة المدى والأهداف؟
